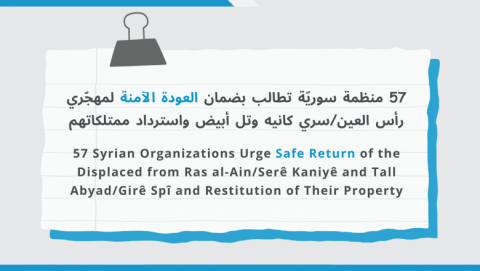(نموذج القامشلي).. بين الارتباك الأمريكي والزحف الروسي
2020-01-03
خورشيد دلي:
تم تقديم مصطلح "نموذج القامشلي"، للمرة الأولى، خلال قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي، في فبراير من العام الماضي، وكان الهدف من هذا النموذج هو مناقشة مصير كرد سوريا في المستقبل. نموذج القامشلي، في الأساس، فكرة روسيةٌ؛ طرحها فيتالي نعومكين، والثاني مستشار بوتين، مدير المعهد الشرقي الروسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط، حيث عمل لفترة طويلة في عدد من العواصم العربية.
ما هو نموذج القامشلي؟. تدور الفكرة حول قضيتين أساسيتين:
الأولى، منح الكرد شكلاً من أشكال الحكم المحلي، شريطة ألا ينفصلوا عن السلطة المركزية في دمشق، فيما الثانية هي منح الحكومة المحلية للكرد إمكانية اتخاذ القرارات السياسية والمحلية، والاستقلال الجزئي في القضايا الثقافية والاقتصادية.
في الحقيقة، نشأت فكرة نموذج القامشلي من عدة عوامل، ربما أهمها ظهورُ الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، في أعقاب قتال داعش، بسبب الفراغ الذي خلّفه انسحاب الجيش السوري المنتظم من هذه المناطق للعديد من الأسباب. تبدو هذه الإدارة حاجة ملحّة لتنظيم واقع الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في هذه المناطق، وبالتدريج أصبحت هذه الإدارة كياناً سياسياً وعسكرياً؛ يبني مؤسساته، ويفتح أبوابه من الخارج للأصدقاء، وبناءً على هذا الواقع فقد طرحت هذه الإدارة مشاريع سياسية، تراوحت بين الكونفدرالية ثم الفيدرالية، قبل أن تتراجع إلى شكل من أشكال الحكم المحلي حول تأثير التطورات في الأزمة السورية، التطورات التي أثرت في قوس مطالب الإدارة الذاتية الكردية، وتصوّراتِ اللاعبين الدوليين والإقليميين، المؤثرين في الأزمة السورية، تجاه هذه المطالب من هذا الإدارة، وربما أبرز هذه التطورات هي:
أولاً، التطور المركزي المرتبط بدمشق. وقد انعكس ذلك على التطورات الميدانية على تأثير نجاح الجيش السوري، بدعم روسي وإيراني، في استعادة السيطرة على مناطق واسعة من غوطة دمشق إلى درعا جنوباً، وإلى مناطق واسعة في ريف حلب وحماة وإدلب.
ثانياً، العامل التركي. بعد احتلال عفرين من قبل تركيا، إثر عملية (غصن الزيتون)، تبدو الشهية التركية مفتوحة للسيطرة على المزيد من الأراضي الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية الذاتية، عملية (نبع السلام) للتعامل.. ضربة كبيرة لهذه الإدارة ومشاريعها وتطلعاتها، خاصة أن العملية التركية استلزمت نشر الجيش السوري في مناطق واسعة من منبج غرباً عبر كوباني "عين العرب" للوصول إلى المناطق في أقصى الشمال الشرقي على نهر دجلة.
ثالثاً، مسار آستّانة وسوتشي. حيث بدأ هذا المسار، متمثلاً بثلاثة أحزاب (روسيا وإيران وتركيا)، في حركته السياسية ضد المسار الغربي، وخاصة الولايات المتحدة في سوريا، وعلى هذا الأساس وجّهت الدول الثلاث سهامها ضد الوجود الأمريكي وحليفه المحلي - قوات سوريا الديمقراطية في الفرات الشرقية، نجحت هذه العملية في منع مشاركة الإدارة الذاتية في اللجنة الدستورية، وفي وقت سابق في مفاوضات جنيف، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على الإدارة، خاصة في ظل اتفاقية النظام والمعارضة ضد المقترحات السياسية للإدارة.
رابعاً، بعد عملية القضاء على تنظيم داعش في معقله الأخير في باغوز، شرق دير الزور، يبدو أن الإدارة فقدت وظيفتها الأساسية في محاربة داعش، الأمر الذي مهّد الطريق لتغيير الرأي الأمريكي الذي أثر بشكل كبير في الإدارة الذاتية.
* الارتباك الأمريكي والزحف الروسي:
كانت الميزة العامة لسياسة الرئيس دونالد ترامب هي الارتباك والارتجال، بخلاف روح الاستراتيجية الأمريكية، وكان هذا الالتباس واضحاً في العلاقة مع الكرد والوجود العسكري الأمريكي في الفرات الشرقية، ويبدو أن مسألة سحب الجنود الأمريكيين كانت نقطة تحول بين تغريدات ترامب اليومية وشبه المؤيدة للانسحاب، وسعي البنتاغون والكونغرس والمخابرات إلى انسحاب مدروس؛ بحيث لا يخلق تداعيات مثيرة للحلفاء وأرصدة القوة، ربما تكون سياسة ترامب هذه قد أربكت العديد من القوى، بما في ذلك ترامب والحلفاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وبريطانيا، بسبب وجود قوات لهاتين الدولتين في شرق الفرات، والحديث عن إنشاء منطقة آمنة مع حماية دولية لمنع الصدام بين تركيا والكرد، ولكن ما حدث هو أن قرار ترامب قلبَ الأمور رأساً على عقب. مكالمة هاتفية شهيرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وإعلان الأخير إطلاق عملية (نبع السلام) بحجة إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، أدت هذه العملية إلى تقطيع المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، وفتحت الباب لخريطة جديدة للقوات المتنافسة على جغرافيا الفرات الشرقية.
مع قرار ترامب، بدا أن روسيا هي المستفيدة الكبرى؛ إلى الحد الذي سلّم فيه ترامب الملفّ السوري بأكمله إلى بوتين. كلما انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة عسكرية في الفرات الشرقية، قامت القوات الروسية، برفقة الجيش السوري، بملء الفراغ. عقب وقف إطلاق النار، تحركت موسكو أيضاً بقوة على مسارين هما:
أولاً، مسار استعادة العلاقة بين أنقرة ودمشق، وفقاً لنسخة معدّلة من اتفاقية أضنة، التي تم التوصل إليها في العام 1998 بين دمشق وأنقرة، في أعقاب أزمة عبد الله أوجلان بين البلدين.
ثانياً، محاولة موسكو التحرك على طول خط العلاقات بين الكرد ودمشق، برغم أن هذه الخطوة أدت إلى تفاهم عسكري بين الجانبين؛ لنشر القوات السورية النظامية في المناطق الحدودية مع تركيا، لتقليل التوغّل العسكري التركي، لكنها ما أفضت إلى أي نتائج سياسية حتى الآن؛ فيما يتعلق بالاتفاق بين الكرد والنظام على حل سياسي.
في الواقع، من الواضح أن روسيا أكثر قدرة على تشكيل المشهد السوري، وتحديد مسار الأزمة السورية وإدارة لعبة الصراع بين الأطراف المتورطة في هذه الأزمة، القرار الروسي بتأسيس قاعدة جوية عسكرية في مطار القامشلي لحماية نظام الصواريخ هو تعبير عن استراتيجية روسية حاسمة لتحديد خرائط مستقبلية في شرق الفرات، وإنشاء مثل هذه القاعدة هو تعبير عن رغبة روسية في البقاء طويلاً، إن لم يكن دائماً، في هذه المنطقة، وحيث يمكنها أن تمارس المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة وتركيا وإيران، لدفع مجرى الأزمة وفقاً للاستراتيجية الروسية التي تسعى إلى دفع هذه الدول إلى سحب قواتها من سوريا.
* النموذج بين السياسي والثقافي
التطورات السابقة، إجمالاً، وضعت النظام السوري و"قسد" وجهاً لوجه، أمام خيار الحوار، تطلُّعاً إلى اتفاق بينهما، يحفظ وحدة الأراضي السورية إزاء مخاطر العدوان التركي واجتياحه، ويحقق في الوقت نفسه عقداً اجتماعياً جديداً، يقرّ بالهوية القومية للكرد، ويحقق شكلاً من أشكال الحكم المحلي لهم. أمام هذا الواقع، ثمة أسئلة كثيرة، لعل أهمها: هل فعلاً يمكن أن تعترف دمشق بالوجود القومي للكرد؟ وهل يمكن أن تقبل بالإدارة الذاتية في شرقي الفرات؟ في المقابل، هل يمكن لـ "قسد" أن تقدم خطاباً واضحاً لجهة الخيارات السياسية النهائية؟ وإلى أي درجة تستطيع أن توفّق ما بين مطالبها المحلية ومحددات العلاقة مع المركز؟ مع الاعتراف المسبق باختلاف وتناقض الرؤى بين النظام و"قسد" بشأن التطلعات التي تطرحها الأخيرةُ، وكيفية التوصل إلى اتفاق بينهما. ثمة محددات ربما تساعد على حوار منشود بين الطرفين، ولعل أهمها:
1- اتفاق الطرفين على أهمية وحدة الصف والجهود في مواجهة العدوان التركي، إذ أبرز هذا العدوان مخاطر حقيقة على سوريا، في شكل أطماع تركيةٍ بالأراضي السورية، واستراتيجياتٍ للبقاء طويلاً في هذه الأراضي، ولو بشكل غير مباشر، من خلال القوى والفصائل المرتبطة بالسلطات التركية.
2- روسيا التي تقدم نفسها بدور الضامن للحوار بين دمشق و"قسد"، ومع أن حدود هذا الدور لم تتضح بعدُ، إلا أن الحوار نجح في دفع الطرفين نحو تفاهم عسكري في مناطق بشرقي الفرات، وهو ما رسم خريطة جديدة للنفوذ والأدوار، وبالرغم من أهمية هذه الخطوة مرحلياً إلا أنها ستبقى دون نتائج حقيقية على المستوى السياسي والاستراتيجي.
3- طبيعة العلاقة والأدوار بين "قسد" ودمشق تشكّل محدِّداً طبيعياً للحوار، إذ لم تشهد العلاقة بينهما طوال السنوات الماضية حروباً أو صراعاتٍ دموية، وفي أحيان كثيرة تقاطعت هذه العلاقة ولا سيما لجهة محاربة؛ حيث ينبغي هنا التذكير بأن اللقاءات لم تنقطع بين تنظيمات إرهابية وأخرى مصنَّفةٍ في المعارضة، طوال الفترة الماضية.
في الواقع، وبعيداً عن تناقضات المواقف بين دمشق و"قسد" بشأن القضايا السياسية المثارة، ثمة تصوّر لدى دمشق بأن التطورات الأخيرة أضعفت من موقف "قسد" وخياراتها، لا سيما في ظل الضغط الروسي واستمرار التهديد التركي. وانطلاقاً من هذا التصور تنطلق دمشق في تصورها للحوار مع "قسد"؛ من حقيقة عدم قبول وجودها كمؤسسة عسكرية وإدارة ذاتية في المستقبل، في حين أن هذا التصور هو ضد المطلبين الأساسيين لـ "قسد"، وهما الاعتراف بالإدارة الذاتية والاعتراف بخصوصية "قسد" في الجيش السوري مستقبلاً. فنموذج الاتفاق الذي تطرحه "قسد" هو شكل من أشكال الاعتراف السياسي، في حين أن دمشق - وكما طرح الرئيس السوري في مقابلته الأخيرة على وسائل إعلام سورية - تدور حول شكل من أشكال الحقوق الثقافية، ولعل حديثه وتركيزه على النموذج الأرمني في سوريا؛ من حقوق ثقافية وتعليمية، كانا رسالة واضحة وموجهة إلى الكرد أكثر من أي مكوّن آخر، مفادها أن النموذج الثقافي هو وحده مطروح للحوار والاستجابة أمام هذا الواقع، ثمة رهان من الأطراف المعنية على عامل الزمن، وتغير موازين القوى والتطورات الميدانية، لترجيح كفّة أي نموذج على الآخر في المرحلة المقبلة.
*كاتب وباحث في الشؤون التركية والكردية