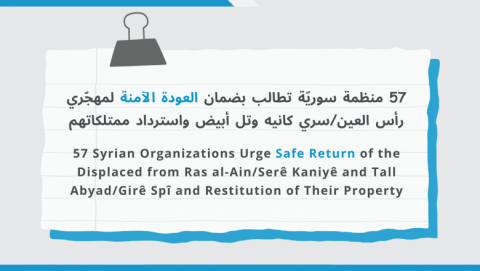الكرد والنظام ... بين مشروعي الإدارة الذاتية والإدارة المحلية
2020-03-24
الكاتب: خورشيد دلي
أفضتْ الجهود واللقاءات والحوارات الجارية على خط الاتصالات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شرقي الفرات إلى طرح صيغتين للتوصل إلى تسوية بين الطرفين، فالحكومة السورية تطرح صيغة قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2012، فيما الإدارة الذاتية تطرح اللامركزية في الحكم، وتقدم تجربتها كنموذج، وإمكانية تعميم هذه التجربة في باقي مناطق سورية بعد سنوات من ممارستها في مناطق بشرقي الفرات. بدايةً، مع التأكيد على أن لكل طرفٍ دوافعهُ وأسبابه وأهدافه من طرح نموذجه الخاص، فإن البعد الجوهري الذي يقف وراء طرح كل طرف نموذجه، هو سياسيٌّ بإمتياز، ويتعلق بطبيعة نظام الحكم المراد تطبيقه في المرحلة المقبلة، بين تجربة نظام مركزي، رسّخ من نفوذه وسلطاته ومؤسساته المختلفة خلال العقود الماضية، ويرفض غيره من النماذج في الحكم، وبين ضرورة الانتقال إلى الحكم اللامركزي لأسباب كثيرة لها علاقةٌ بالمستقبل.
- في دوافع الانتقال إلى اللامركزية:
الدعوة إلى اللامركزية في الحكم، تُحيلنا تلقائياً إلى البحث عن الدوافع من وراء هذه الدعوة على شكل قراءة الدوافع والأسباب والموجبات، والتي يمكن تلخيصها في جملة قضايا أساسية. إذ في الواقع، ثمّة دراسات كثيرة عن الأسباب التي تقف وراء اللجوء إلى نظام اللامركزي في الإدارة والحكم، وغالبا ما تتفق هذه الدراسات على مجموعة من الأسباب، لعل أهمها:
1-ضرورة تنظيم العلاقة بين المركز والإقاليم أو المحافظات أو الأطراف، إذ أن تنظيم هذه العلاقة له أسباب جغرافية، لها علاقة بموقع العاصمة من المناطق البعيدة، وضرورة عدم حصر السلطات بالمركز الذي غالبا ما يتحول إلى مركز بيروقراطي مُعيق لتطور المناطق البعيدة.
2-أسباب لها علاقة باختلاف الهويّة (الدينية – القومية – الطائفية – الثقافية)، إذ أن النظام اللامركزي عكس النظام المركزي يوفرا قدراً كبيراً من المناخ لممارسة مثل هذه الهوية التي تشكل إحدى مكونات الدولة اجتماعياً وسياسياً وتاريخياً، وبما يضمن دستورياً لهذه المكونات التعبيرَ عن هويتها وتطلعاتها. 3-أسباب اقتصادية واجتماعية، لها علاقة بكيفية تحقيق التنمية؛ إذ أن اللامركزية توفر قدراً كبيراً من المشاركة المحلية في رسم الخطط الاقتصادية والمشاريع الإنتاجية التي تناسب كل منطقة ومواردها. كما تحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية التي تعزز من الاستقرار وتحد الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى ولاسيما العاصمة دمشق.
4-أسباب سياسية لها علاقة بكيفية المشاركة المحلية في الحياة العامة، وتوزيع الثروة بشكل عادل، وتحفيز الكفاءات المحلية، وتعزيز التنافسية المناطقية، بما يؤدي كل ذلك إلى الحد من المركزية التي غالباً ما تحصر السلطة في شخص معين أو حزب سياسي أو قومية أو دين أو حتى مؤسسة عسكرية، بما يعزز كل ذلك من الديمقراطية وممارستها وتطوير مفاهيمها. هذه الأسباب وغيرها، دفعت بكثير من الدول خلال العقود الماضية للانتقال من الحكم المركزي إلى اللامركزي، سواء بشكله الإتحادي أو الكونفيدرالي أو الفدرالي أو حتى الحكم الذاتي، إذ أن هذه النماذج هي التي تقف وراء التجارب الناجحة للحكم في دول أوروبا والولايات المتحدة، وفي منطقتنا دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما معظم أنظمة الحكم في الشرق الأوسط تنظر بعين سلبية إلى مفهوم اللامركزية في الحكم، فأنظمة الحكم المركزي التي تشكلت في هذه المنطقة بعد حقبة الإستقلال، تنظر بسلبية كبيرة إلى النظام اللامركزي في الحكم، إذ أن الشك يغلب على هذه النظرة، إذ غالبا ما تنظر إلى الأمر بوصفه مؤامرة من أمريكا وأوروبا وإسرائيل، بهدف تقسيم دول المنطقة وتفتيتها.
في الواقع، هذه الرؤية الضيقة في النظر إلى اللامركزية في الحكم، غالباً ما تقف وراءها أسباب لها علاقة بطبيعة الأنظمة التي تشكلت في المنطقة، إذ أنها معظمها أنظمة جاءت من خلفيات عسكرية أو حزبية أو إيديولوجية أو دينية ترفض التنوع والتعددية. والغريب أن هذه النظرة أو الرؤية تخالف تلك التجارب التاريخية الممتدة في تاريخ المنطقة، وهنا ينبغي التذكير بأن أنظمة الحكم في العهدين الراشدي والعباسي وحتى العثماني شهد نماذج مهمة من حكم الولايات الذي كان قريباً من مفهوم الفدرالية في يومنا هذا ، حيث كانت صيغة الحكم بين المركز وهذه الولايات تقوم على دعامتين أساسيتين: الأولى هي الولاء للحاكم، والثانية فع الضرائب لسلطة المركز، مقابل وجود صلاحيات واسعة للحكام المحليين في إدارة شؤون ولاياتهم ومناطقهم على مختلف الصعد، وقد وصل الأمر في هذه التجارب إلى تشكيل مجالس محلية للحكم في كل ولاية، وهي مجالس تشبه كثيراً في يومنا هذا الحكومات والبرلمانات المحلية في الولايات القائمة في الدول الاتحادية والفدرالية والكونفدرالية أو أنظمة ولايات ذات الحكم الذاتي.
- في جدل المفاهيم ودلالاتها:
في معرض الحديث عن جهود للتوصل إلى اتفاق أو تسوية بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، جرى الحديث عن مفهومين للحل كما قلنا، قانون الإدارة المحلية الذي تطرحه الحكومة السورية، حيث صدر هذا القانون بمرسوم تشريعي في عام 2011، وقد عرف بالقانون رقم 107، وأقرّ في عام 2012 ، ودخل حيز التنفيذ وفق البندين 130 و131 عام 2014، وهو يؤسّس لشكل من أشكال القانون الإداري المتعلق بإدارة البلديات على أساس خدمي ومالي، فيما مفهوم الإدارة الذاتية أوسع، إذ له جوانب إدارية واجتماعية وثقافية وسياسية في المناطق الواقعة تحت نفوذ هذه الإدارة، ولعل إختلاف المفاهيم هنا، له علاقة بالجوانب القانونية والدستورية، إذ لكل مصطلح دلالاته المحددة والتي بموجبها تحدد الصلاحيات ومداها وجوانب الفصل بين صلاحياتها، والسلطات والمؤسسات الأخرى المعنية.
صحيحٌ أنّ الإدارة المحلية كمفهوم، لها شخصية اعتبارية إدارية ومالية، ولكن هذه الشخصية مفوّضة من المركز أو من يُمثّله في المحافظة، بمعنى أنها في النهاية تتبع للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي يتألف – حسب قانون الإدارة المحلية - بشكل أساسي من وزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظ في كل محافظة، فضلاً عن سلطة فرع الحزب ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) في كل محافظة التي هي على علاقة بكل المؤسسات المحلية في المحافظة ( قانون الإدارة المحلية لا يشير إلى دور أمين فرع الحزب ) ، في حين أن مفهوم الإدارة الذاتية أوسع من ذلك، وعلى درجة كبيرة من الاستقلالية في الإدارة والخطط والميزانيات وصولاً إلى التعبير السياسي والاجتماعي عن المكونات التي لها هوية ثقافية أو قومية أو دينية.
في جدل النقاط المتداخلة بين الإدارة المحلية والإدارة الذاتية، يمكن التوقف عن النقاط التالية:
1-تخضع الإدارة المحلية لقيود متداخلة، وسلطاتها إدارية فقط وتحدد من قبل المركز مسبقاً، فيما الإدارة الذاتية غير خاضغة لمثل هذه القيود، وكثيرا ما تضع هي سياستها المحلية وخططها بعد أن تقدمها للمركز في إطار الشراكة وليس كمجرد جهة منفذة.
2 – في ضوء النقطة السابقة، فإن سلطة الإدارة المحلية هي سلطة مفوّضة، وتكاد تنحصر في الجوانب الإدارية، فيما سلطة الإدارة الذاتية مكتسبة، وهي تعد منجزاً سياسياً وإدارياً معاً، تحفظ بموجب الدستور والقوانين.
3-إن المركز ومن خلال تركيزه على الجانب الإداري فقط، لا يقدم أجوبة على قضايا التنوع الثقافي والسياسي المتعلقة بتعدد الهويات، فيما الإدارة الذاتية تقدم نفسها على أنها قادرة على التعبير عن هذا الجانب، وتحقيقها في إطار الدولة المدنية القائمة على التعددية والديمقراطية.
4-إن سلطة الإدارة المحلية هي مرهونة بالمركز ويمكن تقويضها بموجب السلطات المشرفة دستوريا، فيما سلطة الإدارة المركزية مكتسبة وتمارس وفقا للدستور الذي لا يمكن إلغاؤها أو تقويضها إلا بموجب تعديل الدستور. في الواقع، ثمة إختلافات كبيرة لجهة المفاهيم والدلالات الدستورية والقانونية، وفي الأساس حتى الإدارة المحلية لها أكثر من مفهوم، على نحو هل هي مجرد إدارة محلية أم حكم محلي؟ وكذلك الأمر بالنسبة للإدارة الذاتية هل نحو هل هي مجرد إدارة ذاتية أم حكم ذاتي؟ وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقة أنماط الحكم المحلي أو الإدارة الذاتية بحكم المركز وسلطته، وما مدى تأسيس ذلك للامركزية في الحكم؟ وهل مفهوم اللامركزية هذه هو إداري فقط أم سياسي أيضا؟
الأسئلة السابقة تشير إلى مدى التداخل والتشابك في الدلالات والمفاهيم من جهة، وفي شكل الحكم وطبيعته من جهة ثانية، وهي أسئلة تشير إلى جملة من المسائل المهمة بخصوص اللامركزية، لعل أهمها:
الأولى: تحديد الشكل المحلي للحكم، وإقرار ذلك في الدستور، كي يصبح هذا الحكم حقا مكتسبا وفق القانون والدستور، وبالتالي خلق مسار سياسي يقدّم أجوبة الديمقراطية والتغيير.
الثانية: تحديد المهام الإدارية والسياسية لحكم الإدارة المحلية أو الإدارة الذاتية بشكل واضح، ومثل هذا الأمر مهم جدا، لتحديد السلطات والصلاحيات، وكذلك الجوانب القانونية للجوء إليها قضائيا عند النزاعات أو تضارب الصلاحيات.
الثالثة: مدى اللامركزية سواء في الإدارة المحلية أو الإدارة الذاتية، ومدى التناسب بين الجانبين الإداري والسياسي، وأبعاد كل ذلك في تنظيم علاقة الأطراف أو المحافظات بالمركز.
دون شك، هذه الجوانب والإشكاليات والتداخلات بين مفهومي الإدارة المحلية والإدارة الذاتية، هي نقاط مهمة للبحث عن أي حل سياسي أو توافق بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وهي قضايا ينبغي التقرب منها بعقل مفتوح بعيدا عن الأفكار المسبقة، والنظرات الضيقة، تطلعا إلى دولة تعددية مدنية تحقق الاستقرار والنمو والتعايش لشعوبها، ففي النهاية المراد هو البحث عن نموذج يخدم التعايش والتنمية والتطور بما يحقق كل ذلك العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية في بلاد دمرتها الحروب والصراعات الإقليمية والدولية. والسؤال هنا، في ظل تمسك كل طرفه بالنموذج المطروح للحل، ما هو المخرج؟ لعل من الخيارات المطروحة، هل يمكن تعديل قانون الإدارة المحلية بحيث تقترب من مفهوم الإدارة الذاتية؟ وكيف للإدارة الذاتية أن تطرح نموذجا محليا يحقق اللامركزية في الحكم؟ الإجابة عن السؤالين قد يشكل مخرجا، ولعل الأمر يتوقف أولا وأخيرا على وجود إرادة حقيقية ورغبة في التوصل إلى حل يحقق التغيير السياسي المنشود.